"يتلهى عن حريق يداهمه بإحصاء رسائل الإعجاب من المولعين والأحباب"، هذا التوصيف يكاد ينطبق على جلّ السياسيين والمفكّرين والمسؤولين والمثقفين في تفاعلهم مع الأزمة الشاملة التي تتهدّد البلاد التونسية في سائر المجالات.
الحريق في هذه الصورة الشعريّة كناية عن الأوضاع البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي بلغت وفق المؤشرات والمشاهد والأرقام منحدرًا قد يفضي إلى الكارثة التي تسبق الفاجعة الجماعية. أمّا الانصراف إلى مراعاة أفق انتظار المريدين والأتباع واستجداء محبتهم وولعهم، فقد تشكّل في الخطاب السياسي الراهن من خلال انتصارات وهمية لا تنبني على الإنجازات والمشاريع الجادة بقدر ما تقوم على التنابز الفجّ السقيم والسجال الفاجر العقيم، ذلك الذي يُصفق له الأنصار ويترجمونه بعبارات الإعجاب والتهيج العصبي من قبيل "زيدو ما زال يتنفس".
تكشف الأمطار الغزيرة في تونس، في كلّ مرّة، عن مشاهد دموية مريعة، إذ تتسببّ في سقوط القتلى وحدوث خسائر مادية هامّة
من الأخطاء المنهجية المعلومة والبديهية سوء ترتيب المشاغل والقضايا والمشاريع، فالهموم الحارقة والحيوية يُفترض أن تحظى بالأولوية القصوى في الخطاب والبحث والتخطيط والبرامج والاعتمادات، وكلّ عدول عن هذه القاعدة الجوهرية في السلوك الفردي أو القيادي أو الجماعيّ لا يمكن اعتباره مجرد خطأ في التقدير إنما هو اختيار منحرف يرقى إلى مرتبة الجريمة، ينطبق هذا الحكم بلا شكّ على بعض وجوه التفاعل مع معضلة المياه في تونس، فبسبب الجهل وغياب الحوكمة الرشيدة والتلهي بالصراعات المفتعلة يواجه المواطن العطش صيفًا والغرق خريفًا وشتاءً.
اقرأ/ي أيضًا: فيضانات نابل آخرها.. أكثر 10 فيضانات دمارًا في تاريخ تونس منذ القرن العشرين
غسالة النوادر والقتل ما سابقية الإصرار
"هبّت رياحية (ريح) وقامت عجاجه، السما غماقت (غمرتها الغيوم)، م اللول ( في البداية) الشتا (الأمطار) نكتت، ثم بخنست، ثم رشرشت، ثم شرشرت وإذا بيها عطات السما ما عندها درجين طّرشقت المازب وطارت النقر (البالوعات) وفاضت القمم. وديان حامله زادمه على البطحاء سيدي محرز بحر، سوق الجزارة بحر، نهج الكبده بحر، حيوط تشرب، حيوت ترخ ( تتهاوى)".
هذا المشهد من مسرحية "غسالة النوادر" يؤكّد ثلاثة معطيات، الأوّل مرجعي توثيقي مفاده أن البنية التحتية في العاصمة وفي كلّ المدن التونسيّة ظلّت تعاني عيوبًا مزمنة منذ عقود، فالعمل المسرحي الذي جسده محمد إدريس وجليلة بكار والفاضل الجزيري سنة 1980 قد حاكى فنيًا مشهدًا ظلّ يتكرّر كلّ سنة، ولئن اقتصرت غسالة النوادر على تصوير ما خلفته الأمطار من قبح وفوضى وتعطلّ لحركة المرور تصويرًا لا يخلو من إثارة وجمالية.
وتكشف لنا الأمطار الغزيرة أو الطوفانية في تونس، بصور ملونة واضحة ومفضوحة، في كلّ مرّة، عن مشاهد دموية مريعة، إذ تسبب هذه الأمطار في سقوط القتلى وحدوث خسائر مادية هامّة في الممتلكات الخاصّة والعامّة.
مسرحية "غسالة النوادر"
أمّا المعطى الثاني الذي كشفت عنه غسالة النوادر فنيًا وواقعيًا، فهو متعلق بحالة الاستهتار الذي تردّت فيها الحكومات التونسية على امتداد ثلاثة عهود مع بورقيبة وبن علي وبعد الثورة. هذا الاستهتار جريمة قد تتجاوز مجرد القتل على سبيل الخطأ، فضحايا الفيضانات هم قتلى مع سابقية الاصرار والترصّد يقوم دليلًا على ذلك تواتر الجريمة في حيّز يكاد يكون محدّدًا وفي زمن مخصوص.
المعطى الثالث الذي يمكن التنبيه إليه يتصل بمسألة تخزين المياه، فتلك المياه التي غمرت البيوت والشوارع والأزقة هي عينة بسيطة من هذه الثروة الطبيعية المهدورة. فقد عجزت الدولة التونسية عن إيجاد سبل للتحكم في مياه السيلان الضائعة، فمياه الخريف والشتاء التي تستأثر بها المناطق الرطبة أو تنحدر إلى البحر أو السباخ، أولى بها وأحرى أن تُدّخر في السدود والفسقيات والجوابي والبحيرات الجبلية حتّى ترفع عنا في الصيف المقبل شبح العطش، في بلد تعدّ من أفقر دول البحر الأبيض المتوسّط مائيًا، وقد تعدّت وفق تقرير نشره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خطّ الفقر المائيّ لتصل إلى مرتبة الشّح.
ما يحدث من استهتار في التعامل مع الثروة المائية ينطوي على تناقض يوحي بالبلاهة والجنون، فمن أبجديات ردود الفعل أن يكون الحرص والتوقّي بحجم الخطر، ومن أبجديات التواتر والتكرار عدم الوقوع فريسة المفاجأة، وهي المعادلة التي ترجمها هشام المشيشي رئيس الحكومة قائلًا "ليس من حقنا مستقبلًا أن نتفاجأ من تهاطل الأمطار"، وذلكإثر الأمطار الطوفانية في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2020، غير أنّ الترجمة الأسلم في ظنيّ "ما كان لنا منذ عقود أن نتفاجأ"، فالإمكانيات والأرقام والأرصاد والمخاطر والحفر والخنادق والبالوعات المسدودة أو تلك التي سرقت أغطيتها كلها عناصر معلومة محفوظة ما عادت تخفى على أحد.
شحّ الطبيعة وعجز العقول
ليتضح المشهد المفزع أكثر، فلنراجع بعض الأرقام التي أعلنت عنها مؤسسات وطنية وعالمية، ونذكر منها أربعة:
- أولًا: انخفاض مرتقب في معدلات الأمطار بين عشرة وثلاثين في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة، وذلك وفق توقعات وزارة البيئة والمعهد الوطني للرصد الجوي، وقد لاحظنا آية على ذلك خلال في مفتتح سنة 2020 التي تحولت فيها أشهر الشتاء إلى أيام حارة رمضاء جافة حارقة.
- ثانيًا: قد يبلغ العجز المائي بحلول سنة 2040 ما يقارب 275 مليون متر مكعب مع فقدان 80 في المائة من الموارد المائية غير المتجدّدة، هذا المعطى أكّده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في كتاب تمّ نشره في صيف 2020 عنوانه "الفلاحة هي الحلّ".
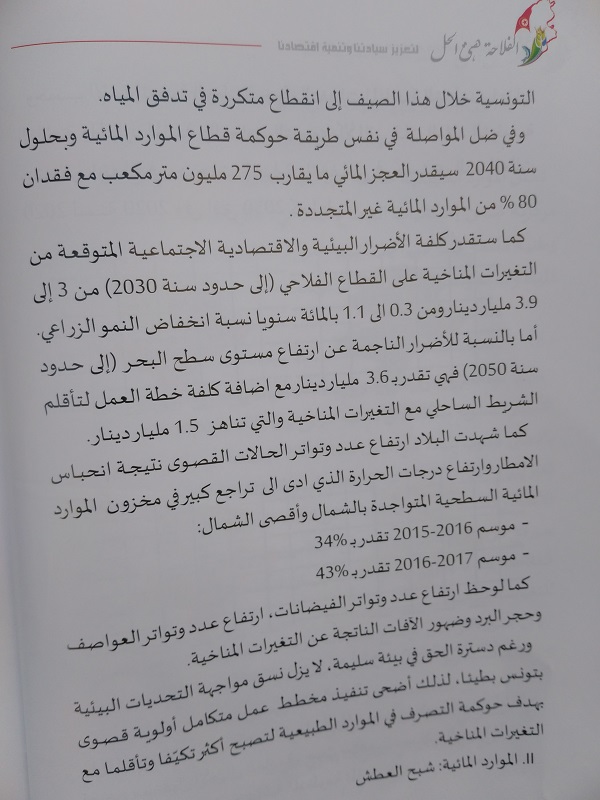
مقتطف من كتاب "الحل في الفلاحة" للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- ثالثًا: نصيب كلّ تونسي من الماء في حالة التوزيع العادل لهذه الثروة لا يتخطّى حاليًا 450 متر مكعب سنويًا وهو أدنى من مؤشر الفقر المائي (500 متر مكعب للفرد في السنة)، هذه النسبة تسير نحو الانخفاض وفق المرجع المذكور لتنزل إلى حدود 350 متر مكعب للفرد سنة 2030 أي أقل من متر مكعب كل يوم مشربًا واستحمامًا وتنظيفًا للمسكن. وفي صورة تواصل الحيف والاستهتار وعدم الانصاف في استغلال المياه، لن يتخطّى نصيب الفرد اللترين يوميًا لقضاء جميع حاجاته.
- رابعًا: إمكانية تراجع الاستفادة من سيلان الأنهار الكبرى (مجردة وملاق) النابعة من خارج حدود البلاد ويرجع ذلك وفق تقرير صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى "تواصل بناء السدود بنسق كبير في القطر الجزائري".
إذا حلّ العطش لن ينفع قمع ولا رشّ
باتت تتبيّن هواجز العطش، أو ربّما انتفاضات العطش، في كل صيف في تونس، فمن من أكثر العناوين تواترًا في الصحف التونسيّة خلال كل صائفة "احتجاجات بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب". هذا اللون من الاحتجاجات إذا تواصلت دوافعه لن توقفه أي آلة أمنية أو عسكرة فإذا حلّ العطش لن ينفع قمع ولا رشّ.
اقرأ/ي أيضًا: تونسيون دون ماء والجمعيات المائية في قفص الاتهام
الاحتجاج لأجل الماء يحسبه القارئ المتعجّل مجرّد حدث راجع إلى تقصير من الجمعيات المائية أو تهاون من قبل الشركة التونسية لاستغلال المياه وتوزيعها، وهو تقييم لا يخلو من وجاهة غير أنّ إعادة النظر كرّة ثانية في عمق وروية تكشف لنا أنّ المعضلة أعمق وأخطر خطورة تقتضي إن لزم الأمر إعلان حالة طوارئ وإطلاق صفارات الإنذار.
لا شكّ أنّ معضلة لندرة المياه في جانب منها طبيعي مناخي يتمثل في انحباس الأمطار والجفاف، لكن هذا الشحّ يقتضي منّا أن نكون أكثر حرصًا على تحصيل الحدّ الأدنى الموجود وحسن ادخاره وتوظيفه باعتباره عملة نادرة وهي دعوة تبررها أرقام أخرى أكثر إثارة للفزع نذكر منها ثلاثة: افتقار السدود رغم ندرتها إلى الصيانة والتعهّد وتعرّضها إلى الإهمال ممّا جعلها موطنًا للترسبات التي تلفظ ما يقارب ثلث طاقة الاستيعاب في عدد منها، فطاقة الخزن الأولية تقدر (وفق ما ورد في كتاب "الفلاحة أولًا") بـ2793 مليون متر مكعب غير أنها بسبب التقصير ما عادت تستوعب أكثر من 2168 مليون متر مكعب، فنسبة النقص تتخطّى الخمس.
تفتقر السدود رغم ندرتها إلى الصيانة والتعهّد وتعرّضها إلى الإهمال ممّا جعلها موطنًا للترسبات التي تلفظ ما يقارب ثلث طاقة الاستيعاب في عدد منها
فسد سيدي سالم على سبيل المثال بلغت نسبة الترسبات فيه 274 مليون متر مكعب أي بنسبة تعادل 43 في المائة من طاقة الاستيعاب، هذا النزيف متواصل منذ سنوات على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يفقد هذا السد كلّ سنة 8.31 مليون متر مكعب من طاقته، وتنطبق هذه الحالة على كلّ السدود تقريبًا فسد سليانة مثلًا فقد 52 في المائة من طاقة استيعابه. ولا يُنسى قطعًا النقص لأسباب طبيعية مناخية والنقص المرتقب لأسباب خارجية (سدود الجزائر) وآخر راجع إلى التقصير.
ومن لم تحركه هذه المنبهات فهو أصمّ صنم لا خير يرجى منه، ولو تحرّك الوعي بخطورة الموقف لهبّ الجميع في ما يشبه النفير لاستصلاح السدود وجهر البحيرات الجبليو وإن لزم الأمر استأنسنا بأيدينا ومعاولنا البسيطة في سبيل اتقاء شرّ العطش. لكن هذه الحماسة حتّى إن توفرت لن تغنينا عن رؤسة استراتيجية تتضافر فيها الأبعاد العلمية والهيكلية والتوعوية والتضامنية وغيرها ممّا يمكن إجماله في مصطلح السياسة المائية
عطش.. وتعطش إلى المبادرات والأفكار
في خضمّ هذه العتمة وفي ثنايا هذا الجهل والإهمال ينبغي الاعتراف بوجود علامات مضيئة، نذكر منها ثلاثًا:
الأولى تتّصل بالبعد التشريعيّ فقد نصّ الفصل 44 من دستور 2014 على أنّ "الحقّ في الماء مضمون، والمحافظة عليه وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع"
هذا الفصل يقتضي عاجلًا أن تنسل من رحمه جملة من القوانين الدقيقة ذات الطابع الزجري، وقبل ذلك ينبغي تفعيل القوانين الحالية، فقد دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى "تنفيذ أحكام مجلة المياه على الإدارة ومؤسسات الدولة نفسها إذا ما تبين أنها تسببت في إهدار المياه وسوء التصرف والتحكم فيها".
لا يتخطّى نصيب كلّ تونسي من الماء في حالة التوزيع العادل لهذه الثروة 450 متر مكعب سنويًا وهو أدنى من مؤشر الفقر المائي
العلامة المضيئة الثانية وعي عدد من السياسيين ومنهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بمعضلة المياه، والإصرار على التذكير بها في جلّ المناسبات، وكان المرزوقي قد أشرف في فيفري/شباط سنة 2014 على يوم دراسي حول المنظومة المائية بالبلاد التونسية في أفق 2030 نظمه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ودعا حينها إلى تحفيز العقل الجماعي الوطني على التفكير في حلول ناجعة لكسب رهان توفير الماء لجميع التونسيين.
العلامة المضيئة الثالثة تتمثل في ظهور بعض الأوامر والمناشير العملية التي تحثّ على الاجتهاد في تخزين الماء والمحافظة عليه وترشيد استعماله منها تمكين أصحاب المساكن من قروض ميسرة عند العزم على بناء ماجل لتجميع مياه الأمطار، وقد يتخذ هذا المنحى الاختياري مسلكًا إجباريًا، فقد أعدت حركة "أمل وعمل" مشروع قانون تصبح بمقتضاها رخصة البناء مشروطة بتهيئة ماجل في كل مسكن.
هذه التشريعات والمبادرات رغم أهميتها قد لا تفي بالحاجة، فالمعضلات الكبرى تقتضي تصورات عظمى ومشاريع عملاقة آفاقها بعيدة تتصف بالمردودية والصلابة والديمومة حينها يمكن النظر إلى المستقبل بثقة وأمل وارتواء.
اقرأ/ي أيضًا:
منسّق المرصد التونسي للمياه: الدولة تتجه لخوصصة قطاع المياه (حوار)
تونس العطشى: عن أزمة المياه من خارج صندوق أيديولوجيا المساواة
